استطاع الروائي العراقي علي بدر، أن يبني صورة ساخرة عن مثقّفي الستينيات من القرن الماضي، الذين أصابتهم حمى الفلسفة الوجودية، بعد أن أبهرتهم فلسفة جان بول سارتر عن العبث والغثيان الوجودي. صورة عبد الرحمان، أو سارتر العرب، كانت مثيرة للسخرية، حتى أن القارئ قد لا يتمالك نفسه بإطلاق ضحكات من بعض المواقف المفارقة والساخرة في الرواية.
عاد الفيلسوف العربي بكنز لا يُقدّر بثمن، زوجة فرنسية شقراء، وفوق ذلك هي ابنة خالة سارتر نفسه
يُطلب من السارد أن يكتب سيرة فيلسوف عراقي، اشتهر في ستينيات القرن الماضي، وعُرف بفيلسوف الصدرية. جاء الطلب من طرف حنا يوسف.
اقرأ/ي أيضًا: توني موريسون.. تأمّلات في مفهوم الأفريقانية في الأدب
ما ميّز هذا الفيلسوف، هو الغموض الذي يلفّ سيرته الذاتية، وتضارب الأخبار حول حياته ونهايته الغامضة. فهو لم يترك أثرًا كتابيًا يُمكن الرجوع إليه لتوثيق فلسفته الوجودية، باستثناء بعض المراسالات القليلة.
"فيلسوف الصدرية الأرعن"، كما وصفه حنا يوسف، لم يكتب في حياته كتابًا واحدًا يشرح فيه فلسفته. هذا يجعلنا نتساءل: هل عزوف الفيلسوف عن الكتابة كان مبنيًا على موقف فلسفي من "الكتابة"؟ هل هو من الذين يعتقدون بأنّ الكتابة مثل السمّ يهدّد حياة الفلسفة؟ وأنّ الفلسفة هي تواصل حيٌّ ومباشر بين الفيلسوف والعالم دون الحاجة إلى توثيق تلك الفلسفة في شكل كتابات؟ أم أنّ الأمر لا يعدو أن يكون مجرّد عجز جوهري لدى فيلسوف بغداد عن الكتابة؟

حسب رأي نونو بهّار، وهي رفيقة حنا يوسف، فإنّ الفيلسوف الذي لا يترك كتبًا، يترك داخل سيرته فراغات كثيرة، تحتاج إلى من يملؤها من كتّاب السيّر المأجورين الذين لا يكتفون بالنبش في الماضي، بل يلتجئون إلى مخيّلاتهم أيضًا. الفكرة الجوهرية هنا أنّ الفلاسفة قد يكونون مجرّد صناعة لمخيلات كتاب سيرهم الذاتية. إنّ السؤال الذي يطرحه القارئ هو: ما الحاجة إلى كتابة سيرة فيلسوف؟ ولماذا لا يكتب الفلاسفة سيرهم بأنفسهم؟
" نعم! كل فيلسوف أرعن. لكن هنالك أرعن يكتب كتبًا تسهّل الأمر على الذين يكتبون سيرته، وهنالك أرعن لا يكتب كتبًا، فيقتضي أن ندفع مالًا لشخص ينقّب ويكذب ويؤلّف، ليصنع منه فيلسوفًا حقيقيًا".(1)
أن تقول نونو بهار بأنّ "الفيلسوف صناعة"، يمثّل من وجهة نظري مفتاح فهم الرواية، لأنّها تدور حول شخصية اختلف حولها الناس، فاضطر كاتب سيرتها إلى إعادة ابتكارها. كان مشروع كتابة تلك السيرة في ذاته يخدم مصلحة ما، أيّ أنه لم يهدف إلى إعادة الاعتبار لشخصية فلسفية كبيرة، و الحفاظ على ذاكرتها، بل كانت تهدف إلى تصفية حسابات مع جيل قديم.
"اكتب ما تشاء وليكن هذا الحمار أعظم من جان بول سارتر، لا يهمني على الإطلاق".(2)
كيف تكون فيلسوًفا؟
بدأت علاقة عبد الرحمان بمعضلات الوجود من شعوره المرير بمركّب النقص، وهو الشعور الذي انفجر داخلهلما، وقف صباحًا أمام المرآة، ليكتشف أنّ الطبيعة لم تهبه عين سارتر العوراء. وفي المقابل، كلما التقى ببائع الخضار الأعور ازداد حنقه على الطبيعة، فهل من العدل أن يمتلك بائع الخضار عين سارتر الفلسفية، في حين لا يمتلكها سارتر العرب؟
لم يكتف فيلسوف الصدرية بتمثّل سارتر على صعيد الأفكار، بل بلغ به الأمر إلى محاولة تمثّله جسديًا، ليكون نسخة مطابقة له. بالنسبة له، فإنّ الجسد عتبة أساسية للدخول إلى عالم سارتر.
الفلسفة لا تصنعها الكتب
عندما فشل عبد الرحمان في العودة من باريس مكلّلا بشهادة جامعية من أرقى الجامعات الباريسية، كان عليه أن يحوّل ذلك الفشل إلى موقف فلسفي، ليُقنع النّاس بأنّ الفلسفة لا تصنعها الشهادات الجامعية، وبأنّ ما يصنع الفيلسوف هي فلسفته وليست الشهادة، ليواجه الوجوه المندهشة بسؤال كبير: وهل كان سارتر فيلسوفا بشهادته؟ لم يعد من فرنسا حاملا لشهادة أكاديمية، بل عاد بفلسفة عظيمة من شأنها أن تنقذ الأمّة من تخلفها الكبير.
لقد عاد عبد الرحمان لأجل أن يحمل للنّاس الغثيان الوجودي، ليقول لهم: إننا نعيش في عالم فاقدٍ للمعنى، وأمام هذا الفراغ العظيم، تسقط كل الأوهام، بما فيها وهم الشهادة الجامعية. ثمّ أنّه عاد بكنز لا يُقدّر بثمن، زوجة فرنسية شقراء، وفوق ذلك هي ابنة خالة سارتر نفسه، وهذا يعني أنّ علاقته بالسارترية ليست فكرية فقط، بل هي علاقة نسب أيضًا، وهذا في ذاته يمثّل انتصارًا حضاريًا لم يحقّقه أي مثقف عربي ( إذا استثنينا حالة طه حسين طبعًا).
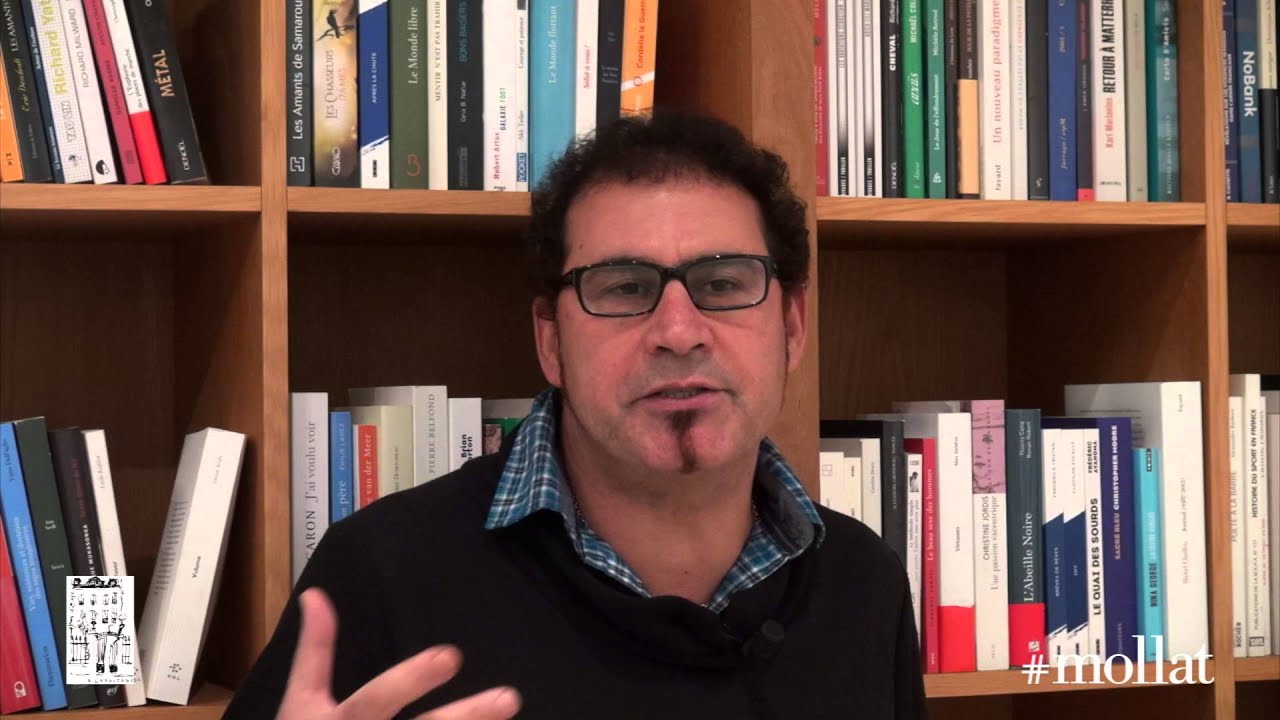
في هذه النقطة بالذات، تعود الرواية لتطرح علاقة المثقّف العربي بالثقافة الأوروبية، من زاوية العلاقة بين الذكر الشرقي والأنثى الأوروبية، وقد أبرزت أنّ زوجة عبد الرحمان الفرنسية، لم تكن مكترثة بشطحات زوجها الفلسفية، ولا بفلسفته الوجودية، ولا بغثيانه العدمي، بقدر ما كانت تجد فيه فحولة الشرقي الذي يروي عطشها الجنسي.
لماذا رفض عبد الرحمان الكتابة؟ يمكن أن نميّز هنا بين خطابين: خطاب ظاهر للاستهلاك العمومي، حاول عبد الرحمان تلميع صورته بوصفه الفيلسوف الذي لم يؤلف كتابًا والذي لا يكتب مقالات، من خلال إبراز موقفه الفلسفي من الكتابة؛ فبالنسبة له فإنّ الكتابة تليق فقط بهؤلاء الذين مازالوا يؤمنون بأنّ هناك نظام في العالم، وبأنّ العالم مؤسس على الحقيقة. فالذين يكتبون يساهمون في واقع الأمر في تشييد السرابات الوهمية، التي روّجت لها الامبراطوريات الامبريالية والرجعية في العالم. ومن جهة أخرى، فإنّ الكتابة تشكل خطرا على حيوية التفكير، وعلى حرارة الانفعالات الأولى التي تصدر عن الذي يتكلم، بل هي تجسد معاني المفارقة والخداع والغرابة بسبب ما تحدثه من مسافات شاسعة بين الفكرة وحقيقتها. إنّ الكتابة مثل العادة السرّية، التي تستبدل الشيء بصورته.
"وهكذا كان عبد الرحمان متكلّمًا، لأنّ الكلام يحقّق له عدمية حقيقية لامجازًا، يمنحه فلسفة واقعية، لا فكرة استعارية. كان عبد الرحمان متكلّمًا لا كاتبًا، كان فيلسوفًا لا دجّالًا" (ص45)
الكتابة بهذا المعنى هي تشييد عالم من المجازات والاستعارات التي تخلق ستارة سميكة، تفصل الفيلسوف عن رؤية الواقع والإحساس به. لأنّ ما سيبقى هو الأثر بدل الواقع.
أمّا الموقف الثاني فهو المضمر الذي يفضح هذه النخب، التي لم تقم على مشاريع فلسفية حقيقية، فما يشكّل موقفًا فلسفيًا في نقد الكتابة، قد يكون مجرّد تبرير لإخفاء مركب النقص في هذه النخب التي عجزت عن إنتاج فلسفة عالمية ترسّخ وجودها من خلال كتابات ومناظرات فكرية موثقة تبقى إرثًا للأجيال القادمة.
اعتمد عبد الرحمان على القاعدة التالية: لم يُخلق الفيلسوف ليعمل بل خُلق ليتفلسف. بهذه القاعدة تهرّب من كل المسؤوليات العملية، ليكتفي بالجلوس في ركن مقهى شعبي، أو في حانة تعجّ بالهامشيين ليُمارس غثيانه الوجودي. الفيلسوف، في صورة عبد الرحمان، هو الذي يجد مبرّرًا لكل شيء. إنّ العمل يعيق الفيلسوف على إنتاج الأفكار العظيمة!
الحب الوجودي..
لا يؤمن عبد الرحمان بشيء يسمّى الحب، فالحب في نظره غير موجود، هو مجرّد حالة ضعف وزيغان تُصيب الوعي فتجعل القبيح جميلاً، ولو لوقت زمني وجيز جدًا، قبل أن تسقط الأوهام، لتتعرّى الحقيقة في قبحها المدوّي. لقد اكتشف بعد أن تعوّد على زوجته الفرنسية الشقراء أنها امرأة قبيحة.
علاقته بزوجته الفرنسية صارت تجسيدًا للإخفاق العاطفي الذي مُني به الفيلسوف، وقد بدأت العلاقة بينهما تفتر يوم رزقا بتوأمين، فاختار لهما عبد الرحمان اسمين غريبين تماشيًا مع فلسفته الوجودية، فالولد أطلق عليه اسم " عبث" و الطفلة اسم " سدى"، وبسبب هاذين الاسمين حدثت القطيعة النهائية بينهما؛ فزوجها الفيلسوف ليس أكثر من رجل مريض وموسوس، فكان قرارها أن تتوقّف عن الاعتقاد بكراماته الفلسفية، وتعيش حياتها متجرّدة من لباس الوجودية ومن أوهام زوجها المجنون. قرّرت أن تربي ابنيها " عبث" و "سدى " بعيدًا عن الفلسفة الوجودية.
جسّد عبد الرحمان سيرة المثقف العربي في تلك المرحلة التاريخية من تاريخ المجتمع العربي الحديث، أي فترة الستينيات، فهو ينتمي إلى ذلك الجيل الذي رفض الدخول في تجربة الكتابة الفلسفية، علما بأنّ الكتابة شكّلت منعطفًا كبيرًا في انتقال الثقافة الإنسانية إلى طور الحداثة وما بعدها، بل ظلّ متشبثًا بالثقافة الشفوية، الصانعة لأوهام بطولية في تفسير التاريخ والواقع. هو جيلٌ لم يعرف من الثقافة إلا ما يُحاك من خطابات عامة في مسامرات المقاهي والحانات، وما يُشيد من جمهوريات أفلاطونية، وما يُثار من حروب وهميّة داخل لغتهم المتعالية عن الواقع.
إننا نرى في صورة عبد الرحمان تجسيدًا أليغوريًا لمعضلة النخب العربية التي انفصلت عن واقعها
إنّه الجيل الذي فشل في تغيير واقعه، لأنّه فشل في فهمه. إننا نرى في صورة عبد الرحمان تجسيدًا أليغوريًا لمعضلة النخب العربية التي انفصلت عن واقعها، وسجنت وعيها داخل عالم من اليوتوبيات المستحيلة.
" ومع ذلك ممالك تُبنى في الكلام، وممالك تُهدّ، عروض يهزها الكلام ويخلخلها، ومدن يصنعها الكلام ويؤسّسها. وليس هناك في واقع الأمر من كان بإمكانه أن ينفذ ما يقول أو من كان بإمكانه أن يُصلح واقعًا، أو حتى يفهم واقعًا". ( ص44).
اقرأ/ي أيضًا:
غادامير قارئًا سيلان.. كيف نقرأ الشّعر؟
النصّ المقّدس والمتخيّل الاجتماعي عند محمد أركون
(1)- الرواية، ص08.
(2)- الرواية، ص12.
