"العنف والحضارة" هو آخر إصدارات الباحث الجزائري أحمد دلباني عن "الوطن اليوم" الجزائرية، ويتناول الوعي بارتباط العنف بنيويًا بالحضارة، ورسالة "متأخّرة" إلى ألبير كامو، يتناول فيها نقديًا منجزه الفكري والذي ما تزال مواقفه من الثورة الجزائرية تخلق ردود فعل متباينة بعد قرابة ستين عامًا مرّت على رحيله.
أحمد دلباني: لقد عاش النقدُ العربيّ طويلًا على وهم الاعتقاد بأنَّ الحداثة مُنجزٌ فنيّ أو فلسفة فنيّة
يتحدّث دلباني في حوار مع "الترا جزائر" عن ثنائية العنف والحضارة، وعن صدور مؤلّفات جديدة تناولت الحراك الشعبي، والتي وصفها البعض بـ"الاستعجالية"، إذ نجد أن للكاتب رأيًا مختلفًا عمّا يقال.
اقرأ/ي أيضًا: حوار | نصيرة محمدي: ولّد الحراك الشعبي سلوكًا تحرريًا
يعتقد الكاتب أن الحراك الشعبي في الجزائر هو امتدادٌ لانتفاضة الشعوب العربية قبل سنواتٍ خلت، و"فصل بهيٌّ" أيضًا من فصولها الراهنة في السودان ولبنان والعراق.
- انطلاقا من عنوان إصدارك الأخير كيف تجمعُ بين المتناقضين: العنف والحضارة؟ وكيف تقرأ مآل هذه الجدلية؟
اخترتُ لكتابي الأخير الذي صدر قبل أيّام هذا العنوان من أجل الإشارة إلى أمر أساسيّ وجوهريّ؛ هو أنَّ ما نعنيه بالحضارة أو المدنية عمومًا لا يعني أبدًا اختفاءَ العنف والتعسّف وأشكال الاضطهاد المعروفة في المجتمعات الإنسانية. تلك غنائية روَّج لها، ربما، الفكرُ الحديث الذي ورث شعارات "الأنوار" الأوروبية وهي تحلمُ بالتقدّم التاريخيّ الذي سوف يصالحُ الإنسانَ مع ذاته ومع المستقبل في شكل انعتاق مشهديّ من "الهمجية" و"البربرية" التي سادت في عصور خلت.
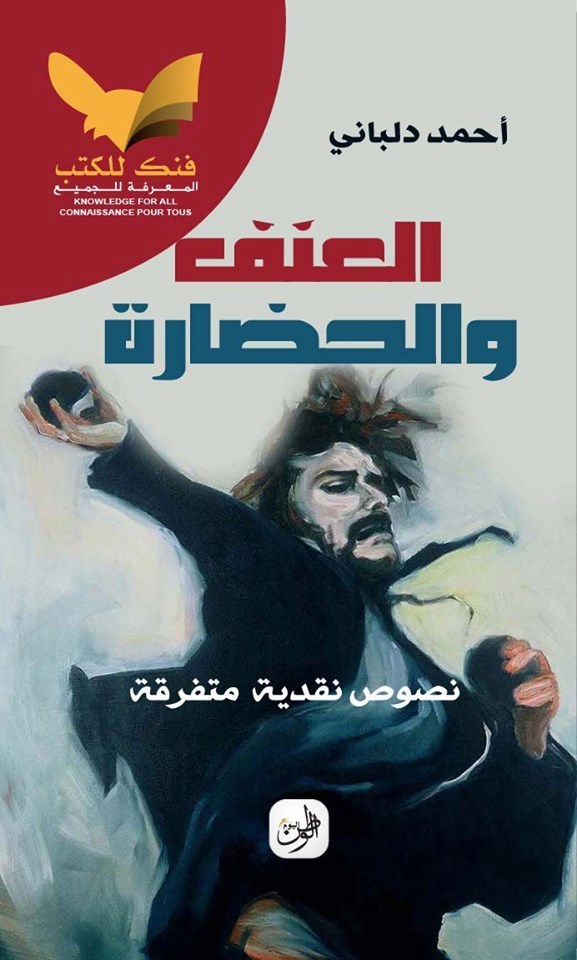
لقد بيَّن الفكرُ النقديّ المعاصر، خلافًا لذلك، كيف أنَّ كل منظومةٍ ثقافيةٍ أو حضارية تُمارسُ تهميشًا لفئاتٍ كثيرة من البشر باعتبارها تمثل تمركزًا حول الذات واستبعادًا للآخر المُختلف. فلكلّ ثقافةٍ، بهذا المعنى، ضحايا ومهمّشون يسقطون من جنّة المركز الذي تمثله بوصفها الثقافة المنتصرة تاريخيًا. من هنا فمن نافل القول أن نقرّرَ أنَّ هناك خيطًا رفيعًا يربط بين الحضارة والعنف. فكل ثقافةٍ هي، بالأساس، بنية عنفية في العمق حتى وإن بدت في صورةٍ مغايرة لذلك.
إنَّ كتابي هذا يضمّ بين دفتيه ثلاثة نصوص نقدية مطولة نسبيًا حاولتُ من خلالها أن أشيرَ إلى بنيات العنف الخفية التي تربضُ في تضاعيف خطابات النزعة الإنسانية والحداثة وغيرها. وأستطيع، بالتالي، أن أقول إنَّ عملي ينخرط في فضاء المساءلات التي تتناول بالمراجعة النقدية ميراث الإيديولوجيات التي صنعت العالم الحديث في صورة زواج مقدَّس بين المعرفة والقوّة.
- رسالتك التي كتبتها للأديب الفيلسوف ألبير كامو قبل سنوات تضمنها كتابك الجديد. ألا تزال تلك الرسالة صالحة في زمن التحوّلات الجذرية التي يعرفها المشهد الجزائري؟
ألبير كامو شخصية إشكالية على أكثر من مستوى على الأقل بالنسبة لنا نحن الجزائريين. فمن جهةٍ أولى هو كاتبٌ كبيرٌ استطاع أن يجعل من أدبه تعبيرًا عن قلق مرحلةٍ برُمَّتها مُقترحًا صيغة أخلاقية للتضامن البشريّ في مواجهة صمت العالم واللامعقول الذي يلفع الحياة بعد انهيار المتعاليات التقليدية، التي كانت تضمن عصمة المعنى في الماضي.
لقد كان كامو شاهدًا على خواء العصر وانفلات مارد البربرية من قمقم ما كنا نعتقدُ أنه يمثل خلاصًا للإنسان في غياب العناية العلوية: أعني بذلك النزعات القومية الشوفينية والشمولية.
ومن جهةٍ أخرى كان كامو مثقفًا نوعيًا أيضًا، وقد مثل تدخّله في الكثير من الأحيان انتصارًا للإنسان والحرّية والعدالة في مجابهة آلة التاريخ الساحقة التي مثلها جنون الإيديولوجيات المختلفة عقب الحرب العالمية الثانية. ولكن هنا أيضًا تكمن المشكلة بالنسبة لنا. فمع احترامنا الكبير للمنجز الكاموي إلا أننا شعرنا بنوع من الخذلان- باعتبارنا جزائريين- من مواقفه التي لم يستطع من خلالها تجاوز انحباسه داخل النزعة المركزية الغربية عندما أنكر علينا طلب الاستقلال ومقاومة الاستعمار؛ فكامو الذي تصدَّى لعنف التاريخ لم يتمكّن من التخلص من عنف الحضارة التي كان وجهًا من وجوهها البارزة. لقد ورث مركزية الغرب الكولونيالي ولكن ليس بصورةٍ فجةٍ بالطبع. أو إن شئتَ قلنا: لم يكتب كامو مديح إشادةٍ بفتح الأندلس ولكنه عمل ما بوسعه كي لا تكون الأندلس، يومًا ما، فردوسًا مفقودًا.
ألا تزال رسالتي إلى كامو في ذكرى مئوية ميلاده صالحة؟ لا أعرف. فكل ما أردت أن أقوله هو أنَّ اختلافي معه كان سياسيًا لا أخلاقيًا. هذا أمرٌ مهم جدًا ويجبُ أن نؤكدَ عليه. ولكنك تعلمُ جيّدًا أنَّ حياة الفكر تخضع، في بعض أوجهها، إلى حاجات العصر الإيديولوجية والروحية وهذا ما حدث مع كامو الذي أصبح يُستعادُ بوصفه مرجعية فكرية وأخلاقية- إنسانوية كان لها أن تُشيرَ- بنوع من البصيرة- إلى مآلات تنصيب التاريخ إلها جديدًا على يد من أرادوا العبورَ إلى المستقبل على الجماجم. لقد كان كامو نبيًا للحاضر المليء ولم ينتظر، يوما، تلك "الصباحات التي تغني"؛ أو الصباحات التي أصابها الخرس بكل بساطةٍ مع فظاعات الغولاغ.
- ما يُلاحظ مع "الصالون الدولي للكتاب" في الجزائر هو هذا "التضخم" الكبير للكتب التي تتناول الحراك الشعبيّ. هل اقتربت هذه الإصدارات من أسئلة الحراك الحقيقية؟ أم هي مجرد انطباعات استعجالية؟
أعتقدُ أنَّ لي رأيًا مختلفا قليلًا حول القضية. فأن تتوفّر كتبٌ حول الحراك الشعبيّ في الجزائر هذا لا يطرح بحدّ ذاته مشكلة قد تصل إلى حدّ تسفيهها أو وصفها بالاستعجال. علينا أن نميّز - تفاديًا لكل لبس – بين مستويين في تناول الأحداث المفصلية الكبرى؛ مُستوى النقاش العام الذي يحاول مواكبة الحدث الانفجاريّ العظيم والتعبير عن مواقف ثقافيةٍ وفكرية وسياسية إزاءه. ومستوى التحليل النقديّ الذي يبلورُ قراءة هادئة ناتجة عن مسافةٍ ضرورية مع لحظة الحدث تُموضعه في سياقاتٍ تاريخيةٍ أكبر ضمن تحولات المجتمع والعالم. ربما نتفقُ، فعلًا، على أنَّ الكثيرَ من الكتابات حول الحراك الشعبيّ لم تخرج عن الأدبيات الصحفية المتسرّعة والمواقف المرتجلة التي لا تستطيع استيعابَ لحظة الحدث في فرادته. هذ الأمر موجودٌ حتى في كتابات بعض المثقّفين ونحن نتفهّم، بطبيعة الحال، سَورة الانفعال والاحتفاء التلقائي الأوّل بالحدث المفاجئ. ولكن هناك بالطبع، في الجهة المقابلة، مستوياتٌ أخرى من التناول الذي يقرأ الحدث ضمن سياق تاريخيّ وسياسيّ أوسع أو يُحاول بلورة مفاهيم جديدة ومفتاحية تتيحُ لنا فهما أعمق لما يجري، أو حتى زحزحة للنماذج التفسيرية السائدة كما حصل مع بعض المفكّرين الكبار وهم يقرأون ما يحدث في زمنهم. لقد بلور ميشال فوكو – على سبيل التمثيل – نظرية جديدة في السلطة بعد فشل ثورة أيّار/ماي 1968 في فرنسا، حاول بها تجاوز البراديغم السائد آنذاك والراكد عند الإسهام الماركسي في هذا المجال كما هو معروف.
أتذكرُ أننا شهدنا ميلادَ مؤلفاتٍ كثيرة لمثقفين ومفكّرين عرب قبل سنواتٍ، حاولوا من خلالها مواكبة انتفاضات الشعوب العربية ضدّ الأنظمة القائمة سنة 2011. لقد كان ما تمَّ تعميده باسم "الربيع العربي" حافزا لمناقشة قضايا التغيير والدولة المدنية والديمقراطية وأدوار المثقفين وغير ذلك من الأمور. هكذا قرأنا ما كتبه علي حرب وأدونيس والراحل سمير أمين تمثيلًا لا حصرًا. من جهتي، صديقي، قادني الاحتفاءُ الكبير بيقظة روح بروميثيوس العربيّ إلى مواكبة الحدث من خلال جملةٍ من المقالات النقدية التي أردتها تحذيرًا من مآلات الثورة في المجتمع التقليديّ، وشروط نجاح التغيير الذي يجبُ ألا يكتفي بقطع "رأس الملك" في غياب ثورة ثقافية وخلخلة لنظام القيم السائدة. هكذا ولد كتابي "قداس السقوط" الذي رأى النور في دمشق سنة 2012.
إنني، صراحة، لا أعتبرُ الحراك الجزائريّ حدثًا فريدًا قد يخلخل باراديغم التفسير الذي نملك، وإنما هو امتدادٌ لانتفاضة الشعوب العربية قبل سنواتٍ خلت وفصل بهيٌّ أيضًا من فصولها الراهنة في السودان ولبنان والعراق. إنه حراك يحمل الشعارات ذاتها ويرمي إلى نفس الأهداف المرتبطة بضرورة "رحيل العصابة الحاكمة" و"إسقاط النظام" الذي تتجمّع في دوائره بؤرُ الفساد والاستبداد والتبعية للخارج ومصادرة أحلام الأجيال الطالعة، من خلال الاحتكار وغلق المنافذ جميعها أمام تطلعاتها المشروعة.
لقد كتبتُ، كما ذكرتُ آنفًا، عن الانتفاضات العربية التي يمكنُ اعتبارها "ثورات مجهضة" وعن عوائق الدمقرطة في عالمنا العربيّ من منظور نقدي يكشفُ عن حدود الحراك العربيّ سوسيولوجيًا وثقافيًا أيضًا.
- بالنظر إلى إصداراتك العديدة التي تناولته، تكادُ تكون المتخصّص رقم واحد في دراسة "ظاهرة أدونيس". كيف تلخّص هذه الظاهرة؟ ولماذا في رأيك لم تتحوّل إلى اتجاه أو مدرسة تسمَّى "أدونيسيَّة"؟
أعتقد أنني قلت ما أردتُ قوله عن صديقي الكبير الأستاذ أدونيس. لقد خصصتُ لدراسته كتابين هما: "مقام التحوّل" الذي صدر في دمشق قبل سنوات، وكتاب "أدونيس، بروميثيوس عربي" الصادر عن منشورات معهد العالم العربي بباريس السنة الفارطة. كما تناولتُ مُنجَزه الفكريَّ والإبداعي في مقالات مبثوثة هنا وهناك. إنَّ ما أردتُ أن أشيرَ إليه بصدد الحديث عن أدونيس هو أنَّ "شيخ الحداثة العربية" لم يُتناوَل إلا باعتباره شاعرًا وهذا بمعزل عن رؤيته الحضارية التي ظلت تشكل خلفية ثقافية/فكرية لمشروعه الإبداعي الكبير.
لقد عاش النقدُ العربيّ طويلًا على وهم الاعتقاد بأنَّ الحداثة مُنجزٌ فنيّ أو فلسفة فنيّة بينما هي – في الأساس– زمنٌ ثقافي وحضاري جديد دشّن عهدَ مركزية الإنسان وتاريخية القيم وانسحاب الآلهة من مسرح التاريخ. هذا ما جعل الكتابة الحداثية، أيضًا، مُغامرة وثورة على منظومة القيم الراسخة ومرجعية الماضي وسلطة الأسلاف.
من هنا قدَّمتُ قراءتي لأدونيس من زاوية نقدية/ثقافية مُحاولًا البحث عن الأسس التي شكلت جذورًا للأدونيسية باعتبارها رؤية شاملة أرادت القذف بالثقافة العربية في زمن الانسلاخ من استبداد المُطلق والمرجعيات المُتعالية تمهيدًا لدخولها زمنَ البكارة وعذرية المعنى. هذا هو المنظور الشامل الذي تناولتُ من خلاله أدونيس. وبالتالي أستطيع أن أقول إنني تطرقتُ في كل ما كتبت إلى "الأدونيسية" باعتبارها رؤية فكرية وإبداعية قامت على جذر ونواة مركزية: أعني تلك الفلسفة الجديدة التي تجعل المعنى لاحقًا لا سابقًا خلافًا للثقافة الموروثة القائمة على مُسبَّقات ومُطلقات ظلّت تعتقل المعنى داخل شرنقتها.
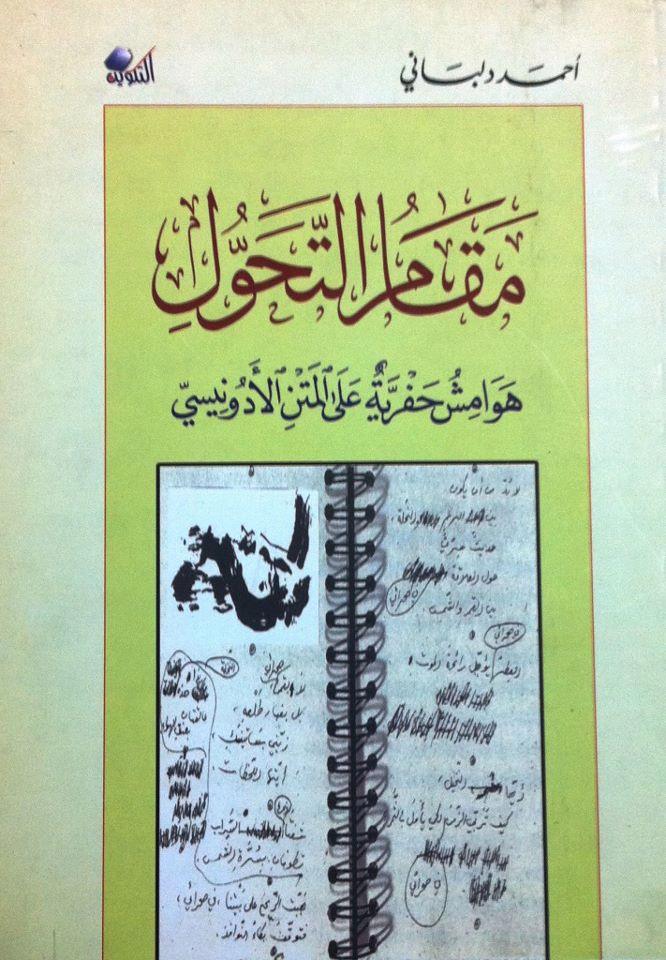
- أخيرًا، ماذا عن أحمد دلباني الشاعر؟ هل حاصرته الأسئلة الفلسفية حدَّ الاختناق؟
لقد نشأتُ شاعرًا يا صديقي كما تعلم. وأنا أعتبرُ نفسي من جيل التسعينيات الذي ولد، ثقافيًا وإبداعيًا، بعد انتفاضة الشباب الجزائريّ في تشرين الأوّل/أكتوبر1988 وفي ظلّ ما عرفته الجزائر بعد ذلك من انفتاح سياسيّ وإعلاميّ. لقد استعادت الكتابة الشعرية، مع جيلي، حقوقها في المغامرة من جديد بعيدًا عن أدبيات الالتزام في صورته المتصلّبة أيام الأحادية الحزبية والثقافية، وأدّى تحطم العكاز الإيديولوجيّ إلى سقوط الكثير من الأصنام الشعرية وإلى تحرير الشعر من العناصر غير الفنيّة وغير الجمالية. كان اهتمامنا يتمحورُ حول كتابة قصيدةٍ جديدةٍ تسافرُ بعيدًا في الذات وتحاول أن تتماهى مع لحظتها بمعزل عن كليشيهات الإيديولوجية الجاهزة.
لم تعد اللغة جسرًا يقودُ إلى العالم وإنما عالما يُستكشفُ ولا تنفدُ عجائبه في الإفصاح عن الكينونة. لقد تمَّ، مع هذا الجيل، العبورُ من الصَّخب الإيديولوجيّ إلى الخيمياء الفنية لغويًا، والانتباه إلى حضور الأشياء الناتئ بفعل ضربة شمس الوعي. كما أتيحَ للمدوّنة الصوفية أن تحظى عندنا باهتمام بالغ أيضًا باعتبارها، أساسًا، تجربة في الكتابة تستثمرُ طاقات اللغة وإبداعيتها من أجل قول المواجيد العميقة في محاولة التماهي مع المطلق. والكلّ يتذكّر ما كان لكتابات أدونيس من أثّر على جيل بكامله في هذا الشأن، وهو يحاول التأصيل لقصيدة النثر في التراث الصوفي.
لقد شهدت الجزائرُ في تسعينيات القرن الماضي بروز الكثير من الأسماء الشعرية المتميّزة التي قطعت مع الذاكرة السبعينية القريبة رؤيويًا وجماليًا. وقد كتبتُ، شخصيًا، عن بعض مناحي هذه الشعرية التي دبَّجت "سِفر العودة" إلى الذات وهي تشهدُ انتكاسة التاريخ وانفجارَ اللامعقول وغرق المعنى، من جديدٍ، في السديم. ولكنني كنتُ مأخوذًا أكثر، حينها، بمحاولة فهم العالم وإيقاع العصر المُتسارع بمعزل عن خطاطات الإيديولوجيات الآفلة. هذا ما دفع بي إلى العكوف على القراءة والتأمل، لسنواتٍ، في المُنجز الفلسفيّ والفكريّ الذي ظل يرقبُ تحوّلات المعنى ويُسائل مصيرَ الحداثة ويحرّرُ النظرَ إلى التاريخ من السَّرديات الخلاصية المُستهلكة.
أحمد دلباني: لم أهجر الشعر بإطلاق وإنما القصيدة باعتبارها شكلًا تاريخيًا شهد ميلادَ الشعر
من هنا وجدتني معنيًا بالكتابة الفكرية التي تحاول احتضانَ لحظتها والسيطرة عليها. أحب دائمًا أن أشبه ما حدثَ معي مُستعيرًا من نيتشه تلك الثنائية الشهيرة التي وردت في كتابه الأول أثناء حديثة عن الإلهيْن أبوللون (إله الشمس والحكمة والعقل والفنون) وديونيزوس (إله العربدة وطقوس السكر والنشوة). فقد انتصرت نسبيًا في ذاتي العميقة، حينها، فضائل أبولون على جنون ديونيزوس؛ وقد تجلّى هذا في توجهي إلى الكتابة الفكرية – النقدية مقلصًا، بذلك، هامشَ الجنون البهيّ الذي تمثله المغامرة الشعرية. ولكن يجبُ أن أنبّهَ إلى أنني لم أهجر الشعر بإطلاق وإنما القصيدة باعتبارها شكلًا تاريخيًا شهد ميلادَ الشعر. فالشعرُ، بمفهومه العميق، نسغ يجري في كل ما أكتبُ لغة ورؤيا.
اقرأ/ي أيضًا:
