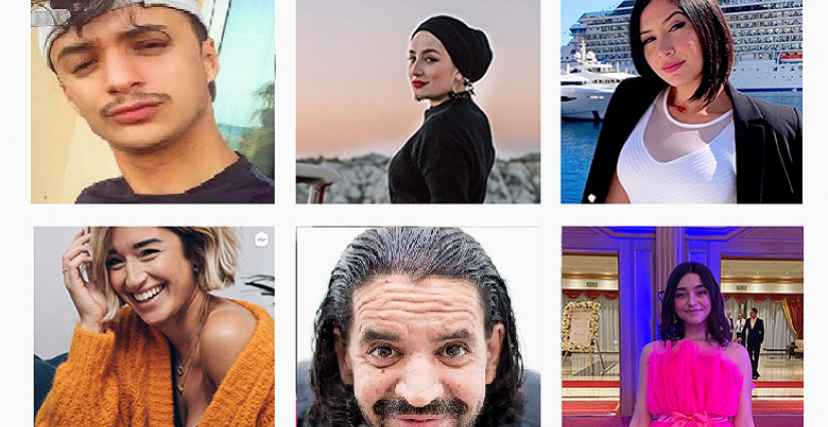في كل مرة تُقَصُّ علينا حكايات "المؤثّرين" الذين يملؤون مواقع التواصل الاجتماعي بكل أنواعها في السنوات الأخيرة، تصعد إلى السطح نقاشات عديدة حول مستوى هذه الفئة التي تتصدر المشهد الإعلامي والإلكتروني، والذي تعتبره نسبة مهمة من المثقفين والمفكرين والصحافيين "مُتدَنِّيًا"، وأنهم "يساهمون في انهيار الذوق العام وفساد الأخلاق"، خاصة أصحاب (البث المباشر) الذي صار موضة تتبعها الكثير من النساء والرجال المغتربين والمحليين بغية الحصول على أعلى المشاهدات التي تذر عليهم أموالا طائلة من عدة قنوات وتطبيقات، من خلال تصوير روتينهم اليومي بكل التفاصيل والحميميات، إضافة إلى نشاطاتهم في البيت وخارجه، ثم اللجوء إلى استغلال الترويج الإعلاني للمنتجات والأشخاص سواءً عن طريق ما يسمى بالتعاون التجاري أو بطلب ملح من المتابعين.
يبدو جليًا أن هؤلاء الذين يشغلون الرأي العام، قد استطاعوا بكل سهولة أن يحتلوا مكانة ظاهرة وحصة معتبرة من المتابعات لدى الجمهور الجزائري
مع ذلك، يبدو جليًا أن هؤلاء الذين يشغلون الرأي العام، قد استطاعوا بكل سهولة أن يحتلوا مكانة ظاهرة وحصة معتبرة من المتابعات لدى الجمهور الجزائري، وتحولوا مع الوقت إلى محور للأحاديث اليومية وعنوانًا للجدل الذي تغذيه قصصهم و"فضائحهم" الكثيرة، كما أنهم الآن مادة دسمة تؤثث يوميات الجزائريين، وتخلق سخط المثقفين.
اقرأ/ي أيضًا: "اللا-دولة" تنافس دولة القانون
في المقابل، تبقى بعض النخب وعدد من الصحافيين، إضافة إلى من يصنفون أنفسهم في خانة "صناع الوعي المجتمعي" عالقين في عنق الزجاجة، حائرين أمام علو هذه الموجة التي تبدو في ارتفاع كبير لا يمكن مجاراته، غائبون، لا أحد يسمع عنهم ولا عن نشاطاتهم الشحيحة، ولا أحد يعرف كيف يتلقف منهم الفكر (الراقي).
فأين تكمن المشكلة إذن؟
في الواقع، يبدو من الطبيعي جدًا في زمن اختلطت فيه مفاهيم الواقع مع الخيال، أن تسيطر أصوات المؤثرات والمؤثّرين على مواقع التواصل ما دام المثقف غائبًا تارة ومغيًبا في أحايين كثيرة، وحتى إن استُحضر في بعض المناسبات، يبقى وجوده عقيمًا في أي حدث أو مناسبة قد تنقص من كرامته وقيمته الفكرية، ففي حين تخصص الدعوات الكريمة والمبالغ الطائلة للمؤثرات والمؤثرين بغية تنشيط المناسبات واللقاءات وعروض الأزياء وافتتاح الأماكن الترفيهية والفنية في مناسبات رسمية سلطوية أو خاصة.
ويتم وصف بعض صاحبات فيديوهات تعليم المكياج وتنسيق الملابس بالرائدات، يُحرم المثقف والفنان والإعلامي من التكريم والدعوات وفرص العمل والشراكات الفنية والأدبية، حتى أن المسابقات الرسمية للأعمال الفكرية والسينمائية تخصص لها مبالغ رمزية هزيلة لا ترقى لقيمة الأعمال وأصحابها، بل إنها تنقص من حماس العمل والاجتهاد لتقديم الأفضل.
يحدث كل هذا، لأن الزمن تغير في الواقع، وصارت الأسماء والشخصيات في بلادنا تعامل على قدر عدد متابعيها أيا كانت صفتهم، لم تعد هنالك دعاية للفكر والعلم والفن، بل صارت الساحة مفتوحة لمسوخٍ ينشطون في كل المجالات التي لا يعرفون عنها سوى نسب المتابعة وكسب المشاهدات على حساب جودة المحتوى المقدم.
من جهة أخرى، تظهر بين الفينة والأخرى أيضا (فئة مثقفة) تشارك بدورها كثيرا في اتساع هذه الهوة، فئة دائمة الامتعاض، قليلة الحركة والنشاط، كثيرة الصراخ والعويل، تشمل من يجلسون في عليائهم مراقبين الآخرين باشمئزاز، في حين أنهم لو فتحوا أعينهم كما بالإمكان أيضا أن يفتحوا المجال لفكرهم السابح عبثا في الملكوت، سيدركون أن الناس البسطاء من حولهم ومن كل فئات المجتمع، صاروا يميلون بالفطرة ويألفون الآخرين الذين يقاسمونهم تفاصيل يومهم ويتماهون فيهم من خلال مشاطرتهم ذلك (الروتين اليومي)، ولو كان هذا الفعل يأخذ الشكل الترويجي لا الحميمي، وإن سلك طوعًا الدرب الخاطئ.
إن الواقع يقول أن المؤثرين في العالم وفي الجزائر خاصة، قد تعلموا جيدًا كيف يكسبون اهتمام المتابعين وكيف يستدرجونهم إلى عوالمهم واهتماماتهم كيفما كانت، (وإن كان هذا المجال يعاني كثيرًا من سوء التسيير والتنظيم والفوضى وشح المحتوى الهادف)، في حين تحشر بعض النخب أنفسها في زاوية مظلمة بعيدة حيث يحلو لها الانتقاد، بغية النأي بنفسها عن جلد الذات، مفضلة إلقاء اللوم كله على تلك الفئة، وعلى كل ما يدبّ خارج هالاتها المغلقة ذات السياج المكهرب.
يلجأ هؤلاء المتعالون إلى تقزيم واستصغار كل من يمشي عكس تياراتهم، وكل من يحاولون أن يثبتوا وجودهم بعيدًا عن تصوراتهم العتيقة، حيث ما يزالون قابعين بفخرٍ واهم، متشدّقين بتدني المستوى ورافعين شعار طغيان الرداءة دون المساهمة في محاربتها.
واقعيَّا، يمكننا بالفعل أن نحارب الظواهر الصوتية الفارغة التي صارت تؤثث مشهدا بائسا تعيشه الساحة الثقافية والفنية والفكرية.
أما السلاح الأنجع، فيُكمن في محاسبة الذات المثقفة والنزول بها صعودًا نحو الآخر لتفهمه، ذَاتٌ واهمة لا تريد أن تواكب الزمن وتصرّ على الهروب نحو الوراء.
فلنتساءل بجدية إذن..
لم لا تستغل النخب الجزائرية الوسائط الإلكترونية لتصنع الفارق، لم لا تعمل على كسب المتابعات بنفس الأسلوب الذي تنتهجه الشخصيات الفارغة على مواقع التواصل، لتنفخ بعدها الروح في جسد الوعي المجتمعي بنفس سلاح التافهين؟
لم لا تفتح عينيك أكثر لترى الركب الذي فاتك بسنوات ضوئية؟ إن هذا التساؤل لا يعني قطعًا أن هذا الركب أرفع منك شأنًا أو يفوقك علمًا وثقافة ونباهة
أنظر حولك أيها المثقف...
لم لا تفتح عينيك أكثر لترى الركب الذي فاتك بسنوات ضوئية؟ إن هذا التساؤل لا يعني قطعًا أن هذا الركب أرفع منك شأنًا أو يفوقك علمًا وثقافة ونباهة، لكنّه على الأقل عرف كيف يسلك طريقًا نحو الأصوات البسيطة، نحو البشر الذين يستكثرون عليك الاهتمام، لأنك في نظرهم لم تعد سوى شخص غريب، ذو شخصية متعالية ومغرورة، تتبنى المعرفة والرقي والثقافة وتستكثرها على سواك، لتبقى جالسًا منحني الظهر، حيث لا يراك أحد وأنت يرمق الجميع بعين الاستصغار.
اقرأ/ي أيضًا:
"جدل الثقافة".. النقد في مواجهة أسئلة الكولونيالية وما بعدها